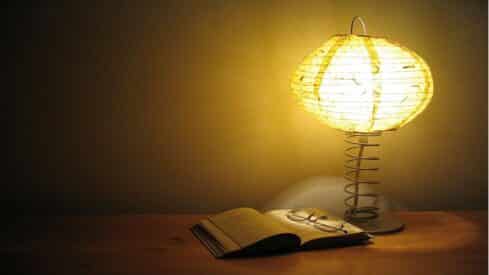
لقد عُني علم أصول الفقه أول ما عُني بإيضاح مصادر التشريع الإسلامي، وعلى رأسها : القرآن الكريم والسنة النبوية.
والركيزة الأساسية للتصديق بهذين المصدرين المقدسين هي (ركيزة إيمانية) .. وعلم أصول الفقه اقترب من هذا (المجال الإيماني) بـ (منهج عقلي) يتعلق (بالثبوت) .. والثبوت مسألة معرفية .. فالقرآن الكريم ثابت بطريق “التواتر”، والتواتر هو ما ينقله جماعة يستحيل تواطؤهم على كذب .. وهذا منهج عقلي أشد صرامة من “المعرفة الاجتماعية” – التي يقول الناس بها الآن- التي تصل للفرد منا ويصدق بها من غير أن يختبر بنفسه أدلة صوابها و/أو ثبوتها، مكتفيا بأنها تنتقل إليه من مصادر شتى ثم أجرت علوم المنهج – أصول الفقه وعلوم الحديث- معايير (التحقيق العقلي) على الأحاديث السنة النبوية المطهرة التي لا تتوافر لثبوتها درجة التواتر؛ من حيث (الضبط) و(التحقيق) بمنهج أكثر صرامة في نسقها العقلي من أساليب تحقيق الوقائع التاريخية، بل من كافة أساليب التحقيق التي عرفها البشر على امتداد تاريخ الإنسانية ..
وهنا نلحظ أن النصوص الأساسية هذه، وهي إيمانية في التصديق بها، قد صارت عقلية في ثبوتها (أي قد تخللها العقل من هذا الوجه المعرفي)، ثم بدأ هذا التخلل يفرض سلطانه – الشرعي- على ما يتلو هذين المصدرين من مصادر أخرى .. فمن المعروف أن النصوص – بمجرد الارتكان إلى ظواهرها- محدودة، سواء نصوص القرآن الكريم أو نصوص السنة النبوية المطهرة، فتفتقت أذهان العلماء عن مصادر أخرى فرعية -استنبطوها من مقررات الكتاب والسنة- تعمل كآليات معينة على استخراج الأحكام من نصوص الوحي .. وفي غالب هذه “المصادر- الآليات” – بل في جميعها- نلمس دورا نامياً وفعالاً للعقل في تفاعله مع الواقع المعيش (1) ؛
أ- فـ “القياس” مثلاً، وهو منهج عقلي معرفي – مستمد من أصول التشريع الإسلامي- يتعلق بإدراك وجه الشبه الفعال بين الظواهر التي وردت فيها أحكام في القرآن أو السنة، والظواهر التي لم ترد فيها أحكام فيهما .. والمهم هنا هو المنهج المعرفي الذي وُضع لإدراك الشبه الفعال، وهو منهج يُعمِل الاستقراءَ لإدراك خواص الظواهر التي تعتبر “علة” للحكم، أي سبباً له، وهو ما يسمى بـ “المناط”. وهنا نلحظ وجوه تجريبٍ واستقراءٍ وملاحظةٍ، ثم استخلاصٍ للصفةِ العلةِ وبلوغٍ للمشتَرَكِ الحاكمِ لما يمكن أن نعتبره متماثلا.
ب- و”الاستصحاب”، وهو منهج عقلي معرفي – مستمد من أصول التشريع الإسلامي- ومؤداه هو بقاء الحال على ما كان حتى يقوم دليل يغيره، فهو يتعلق “بالإدراك” البشري للواقع، ومؤداه أنه عند التيقن من وجود أمر ما، فنحن نتصرف على أساس أنه موجود بعد ذلك حتى يتبين لنا أن ثمة تغييرا أو تعديلا حدث. وما ثبت باليقين من ذلك لا يزول إلا بيقين مغاير.
ت- و”الاستصلاح” أو المصالح المرسلة، وهو منهج عقلي معرفي – مستمد من أصول التشريع الإسلامي- وحاصله هو التصدي المباشر للواقع الحادث والعمل بما فيه مصلحة الناس، وذلك فيما ليس فيه أمر أو نهي ديني ورد بالقرآن أو السنة. والنظر في هذا الشأن يكون بملاحظة أن كل الأوامر والنواهي الدينية إنما قُررت من الله سبحانه لنفع الناس ولإصلاح شؤونهم.
والفقه الإسلامي – كما هو معلوم- يقوم على نوعين من المبادئ:
أ- مبادئ مستقاة من الوحي: قرآنا وسنة (باعتبارها – أي هذه المبادئ- مجسدةً للشريعة مقاصداً وضوابطاً)
ب- ومبادئ مستمدة من الخبرة التاريخية (لما تفيده في تعيين آليات تحقيق المقاصد وإعمال الضوابط)
وكلا الأمرين يتدخل فيه العقل (بمعنى أن للعقل في تلك الأمور عملاً يؤديه) بشكل كبير؛ بدءً بفهم الوحي قرآناً وسنة، ومروراً باستلهام المبادئ المستمدة من الخبرة التاريخية (العلمية والعملية، النظرية والتطبيقية، الأكاديمية والواقعية) لتحقيق المقاصد وإعمال الضوابط.
وإنما قصدت سوق الأمثلة للأساليب والمناهج التي يتفاعل بها الفكر الديني (بنصوصه الثابتة)، مع مناهج إعمال العقل من ناحية، ومع أساليب التعرف على الواقع ومناهجه من ناحية أخرى .. وذلك كله ينفي قطعاً توهم وجود إشكالية في العلاقة بين (النص) و (العقل)، بل يؤكد أن للعقل أهمية كبرى في التعميق التأسيسي والتأصيلي والتفريعي للفقه الإسلامي (2) .
أرأيتَ منزلة العقل والتعقل والتفكر والتدبر في دين الله، إنها واللهِ لعظيمة !
وأما من يضع (العقل) نداً (لله) تعالى، فهو (مُؤَلِّهٌ لعقله) لا (مطيعٌ لربه) ! ولا أعلم لماذا آمن بالله أصلاً ؟!
نعم، «العقل» ملكة من أعظم ملكات الانسان، ونعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليه، لكنه على عظمته وضرورته ـ ككل ملكات الانسان ـ «نسبي» الادراك، ولذلك، فإن الاعتماد على العقل وحده ـ دون «الوحي»، الذي هو علم الله المطلق والكلي والمحيط ـ يقف بالانسان عند «النسبي» و«الظني»، اللذين هما غاية الاجتهاد الإنساني، ويحرم الانسان من «اليقين» الذي سبيله العلم الإلهي ونبأ السماء العظيم.
وأزيد على ذلك فأقول : إن من نعم الله علينا أن جعل العقل هو الذي يدرك بنفسه عجزَه وقصورَه عن إدراك بعض – أو أكثر- ما حوله (ذواتاً أو ماهيات)، وبذلك عرفنا عجز العقل بالعقل نفسه، فكان هذا أشد إقناعاً وألزمَ حجةً .. نعم، إن العقل هو الذي يكشف الحقيقة، ولكنها – في كثير من الأحيان- حقيقة نسبية مقيدة بظروف الزمان والمكان.
العقل، على عظمته وضرورته، إنما قصاراه – في كثير من الأحيان، بل في أغلب الأحيان- أن يدرك الأعراض والظواهر والخصائص والآثار، أما إدراك الكنه واليقين فسبيله الإيمان والعلم الإلهي الكلي والمطلق والمحيط (3) .. ولذلك اختُص المنهاج الاسلامي في المعرفة بتزامل وتكامل آيات الله في كتابيه: كتاب الوحي المسطور وكتاب الكون المنظور .. واختل هذا التوازن في معارف الحضارات التي أخذت بشق منهما دون الآخر؛ فغرق البعض في «المادية» وحدها، واستغرق البعض في «الباطنية» دون سواها ! (4)
نعم، العقل مناط التكليف، وغير العاقل لا ينال شرف التكليف من الله تعالى؛ إذ التكليف لا يكون إلا لمن أمكنه علم الحق والعمل به، ومعرفة الباطل واجتنابه، وهذا لا يمكن إلا من أهل العقول.
نعم، العقل هو إحدى الضروريات، أو الكليات، التي لا قوام للحياة ولا استقرار لها بدون حفظها.
نعم، لقد أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه لإبلاغ الناس دينه الحق، مبيناً لهم بالحجج والبراهين أن ذلك الدين حق، وأن ما خالفه باطل، ملجئا عقول البشر جميعاً – بتلك الجج والبراهين- إلى التسليم الاختياري بأن دين الله حق، وأنه الهُدى والرشاد، وأنه جالب لمصالحهم في الدارين، واقٍ لهم من المفاسد فيهما .. فأقام الله قضية الإيمان – وهي رأس القضايا- على الحجة والبينة التي يدرها العقل – دون سواه- بالتأمل والتفكر والتدبر !
نعم، كل ذلك لا ننازع فيه، بل ونجهر به، فمقامُ العقل في الإسلام مقام لا يخطئه البصر ولا تخطئه البصيرة؛ وكيف لا نجهر به، بله أن نازع فيه، والقرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه، ولا تأتى الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبه في سياق الآية، بل هي تأتى في كل موضع من مواضعها مؤكَّدة جازمة باللفظ والدلالة، وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهى التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله، أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه؛ قال تعالى: “ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون” [الأنعام 151] .. “يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون” [آل عمران 65] ..
إذن الغاية من وجود العقل أن يدل الإنسان ويعرفه على الطريق السليم، ويفرق به بين الحق والباطل، ويقيم به الأمور، وهو حجة على الإنسان يوم القيامة .. وإلا فكيف سيحاسبنا الله إن كان العقل ليس بحجة ؟! ؛ فالإسلام قد جعل العقل مناط التكليف، أي جوهر إنسانية الإنسان .. والقرآن وهو المعجز لم يأت ليدهش العقل، فيشله عن التفكير كحال المعجزات المادية، وإنما جاء القرآن معجزة عقلية، تحتكم إلى العقل في فهمه وتدبره، وفي استنباط الأحكام من نصوصه، والتمييز بين المحكم والمتشابه في آياته، بل لقد جعل القرآن الكريم من البراهين العقلية السبيل للبرهنة على وجود الخالق، وعلى الخلق في هذا الوجود؛ فالمنهاج القرآني يقدم الإيمان بوجود الخالق الواحد على الإيمان بالنقل وبالرسالة التي حملت إلى الناس هذا النقل، وذلك لأن الإيمان بصدق النقل متوقف على الإيمان بصدق الرسول، والإيمان بصدق الرسول متوقف على الإيمان بوجود من أرسل هذا الرسول، فلا بد من الإيمان أولا بوجود الخالق، الذي بعث الرسول، وأنزل عليه الكتاب .. وطريق ذلك هو العقل، الذي يتدبر المصنوعات فيؤمن بالصانع القدير لهذه المصنوعات .. و”ربنا عرفوه بالعقل” كما يقول الناس جميعاً !!
كيف لا نجهر بذلك، وآيات القرآن الكريم التي تحض على العقل والتعقل تبلغ 49 آية .. أما الآيات التي تتحدث عن “اللُّب” بمعنى عقل وجوهر الانسان فهي 16 آية .. كما يتحدث القرآن عن “النُّهى” بمعنى العقل في آيتين، وعن الفكر والتفكر في 18 آية .. ويذكر الفقه والتفقه بمعنى العقل والتعقل في 20 موضعاً .. ويأتي العقل بمعنى التدبر في أربع آيات، وبمعنى الاعتبار في سبع آيات .. أما الآيات التي تحض على الحكمة فهي 19 آية .. ويذكر القلب كأداة للفقه والعقل في 132 موضعً .. ناهيك عن آيات العلم والتعلم والعلماء التي تبلغ في القرآن اكثر من 800 آية.. وبهذا يتضح – بمجرد دليل الإحصاء لا غير- لكل مَنْ له عقل أن النقل الاسلامي – وهو الشرع الالهي- هو الداعي للتعقل والتدبر والتفقه والتعلم، وأن العقل الإنساني هو أداة فقه الشرع، وشرط ومناط التدين بهذا الشرع الالهي.
كل ذلك أجهر به وزيادة؛ فلا أثر للشرع من دون العقل، ولكني أجهر كذلك بأنه لا غِنى للعقل عن الشرع – وخاصة فيما لا يستقل العقل بإدراكه من أمور الغيب وأحكام الدين- ؛ لأن العقل مهما بلغ من العظمة والتألق في الحكمة والإبداع هو ملكة من ملكات الانسان، وكل ملكات الانسان – بحكم “الخبرة التاريخية” و”المعاصِرة”؛ أعني بحكم “الاستقراء” و”الواقع”- هي نسبية الإدراك والقدرات؛ تجهل اليوم ما تعلمه غداً، وما يقصر عنه عقل الواحد يبلغه عقل الآخر.(5)
ونُذَكِّر في الختام بالقول البليغ لعلمائنا – والذي ركبتُهُ من أقوال الغزالي وابن تيمية وابن خلدون والشاطبي، على الترتيب- : “مثال العقل : البصرُ السليم عن الآفات والآذاء، ومثال الشرع : الشمسُ المنتشرة الضياء؛ فالعقل مع الشرع نور على نور .. العقل شرطٌ في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، والأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل – أعني قَطْعِيَّهُ- باطلة .. العقل ميزان صحيح، وأحكامه القطعيةُ يقينيةٌ لا كذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزِن به كل ما وراء طوره أو أن تعلم به ما يفوق حدود معرفته؛ فللعقول في إدراكها حدود تنتهى إليها لا تتعداها؛ إذ للعقل سبيلٌ إلى إدراك كل مطلوب” (6)
ونذكر كذلك بالقول الآتي – والذي ركبته من أقوال محمد عبده وأبي حامد الغزالي الراغب الأصفهاني وكاتب هذه السطور- :
“كلٌّ مِن العقل والعدل مِن الأمور الثابتة في نفسها، فكل ما قام عليه البرهان العقلي فهو حق وإن لم ينص عليه في الكتاب .. وكل ما قام به العدل فهو حق وإن لم ينص عليه في الكتاب ..
وكل ما أرشد إليه الوحي فهو حق ..
فإنه تعالى هو المُنَزِّل – أي المعطي- للعقل والعدل، والفرقان والميزان، كما أنه سبحانه هو المُنَزِّلُ – أي المعطي- للكتاب ..
ولسنا نستغني بشيء من مواهبه المنزلة عن الآخَر ..
فالعقلُ والعدل والشرعُ نور على نور ..
والعقل شرعٌ من الداخل, والشرعُ عقلٌ من الخارج ..
والعقل والعدل والشرع لا تخرج في حقيقة أمرها ونهايته عن أن الله قد أرشد إليها وعوَّل عليها وأمر بها .. فهي كلها طرق شرعية .. وهي كلها طرق عقلية .. وهي كلها طرق عدلية”
وبهذا البيان نؤسس لـ (عقلانيتنا المؤمنة)، وندفن إلى الأبد (صيحات عبيد التنوير الغربي) التي تقول : لا سلطان على العقل إلا للعقل وحده دون سواه !
